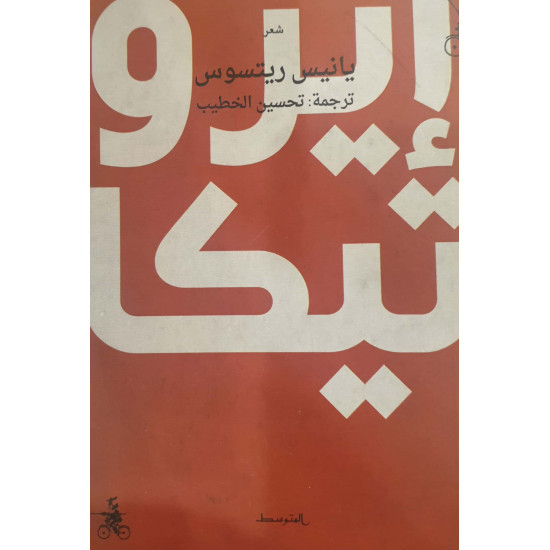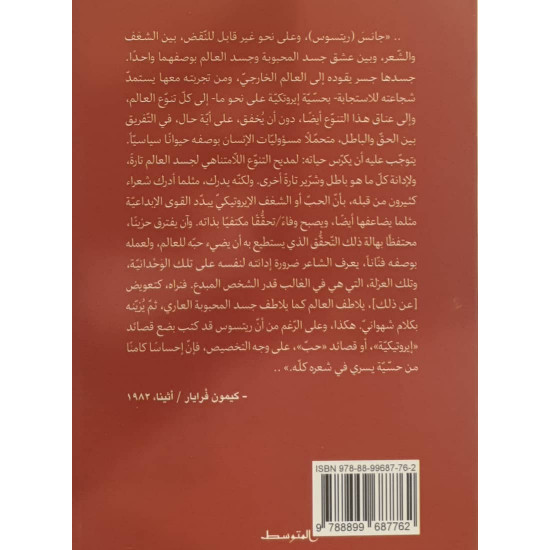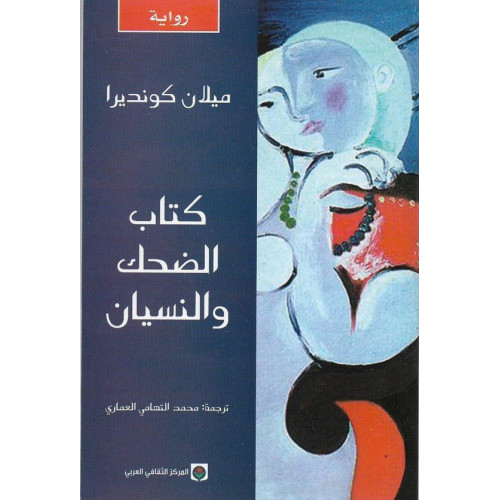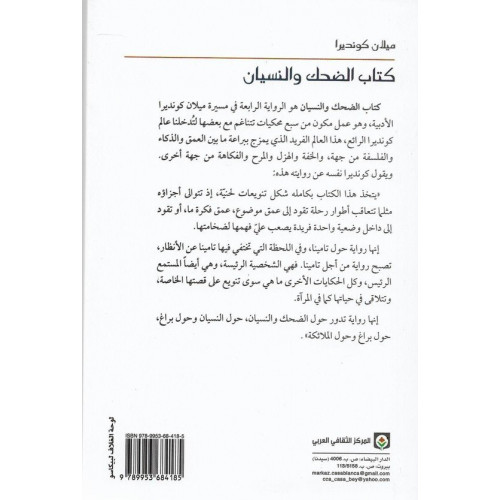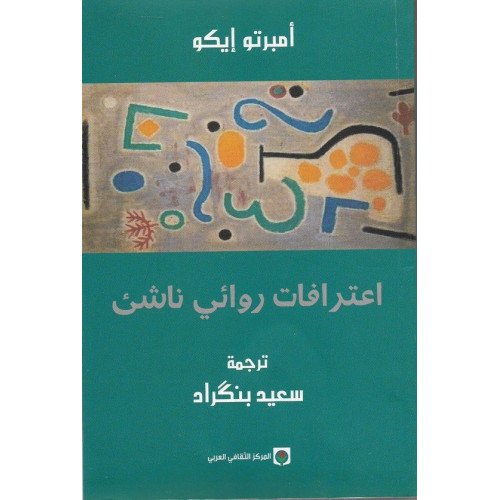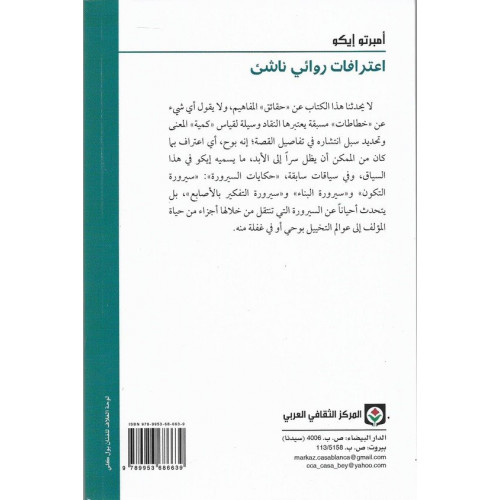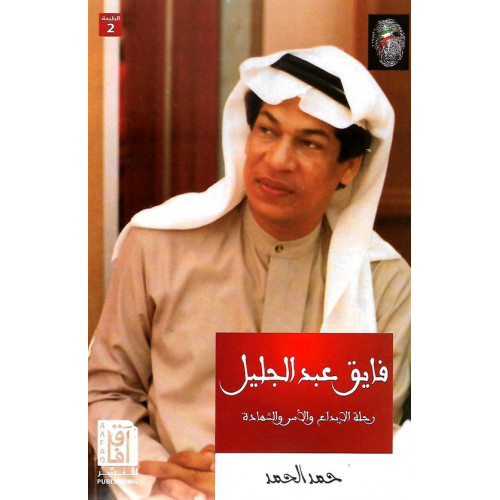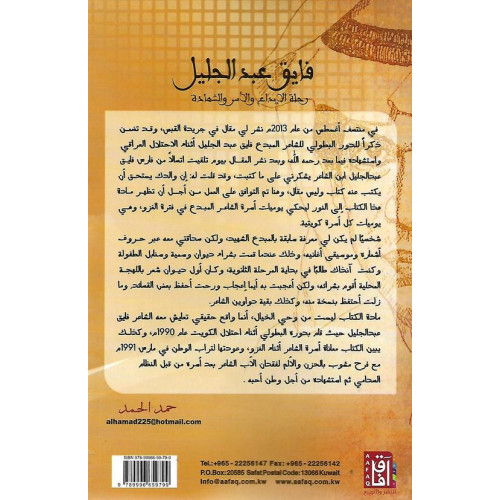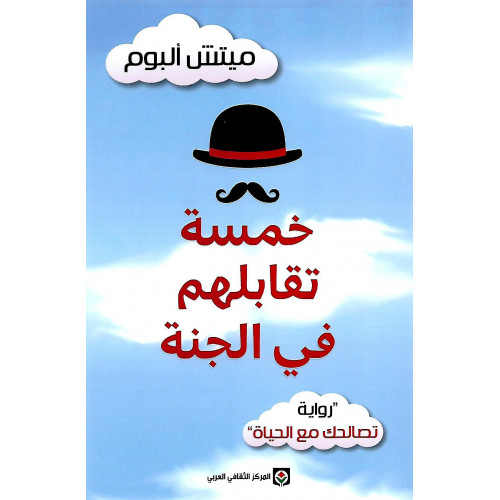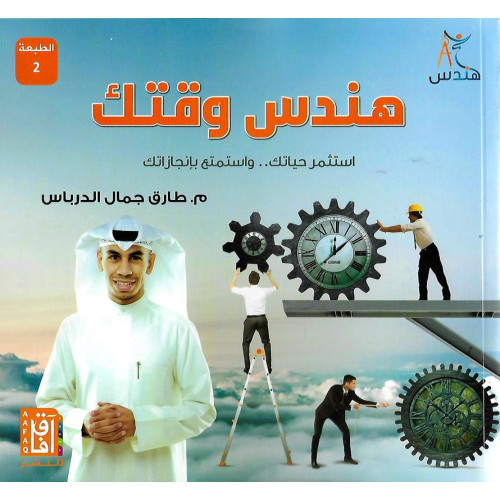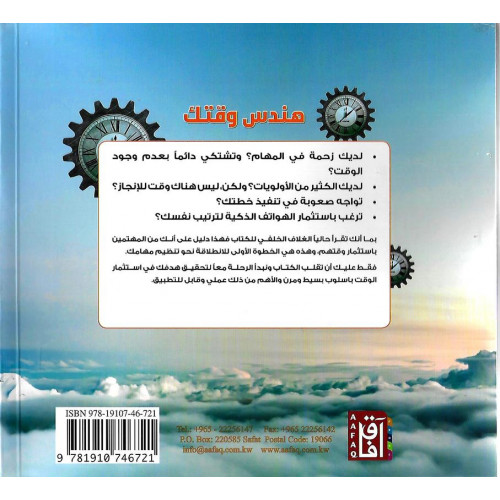الوصف
«تدور عينُ ريتسوس، ذات الأوجه المتعدّدة، في زاوية من 360 درجة، فتنغلق على نفسها تدريجيًا، لتلتقط تفصيلًا تلو آخر، ثمّ ترتدُّ إلى نفسها، فتنفتح على اتّساع محجرها، كاشفةً عن تصميم لا بُدّ أنّها قد أبصرته من علوٍّ شاهق، ليكون مفسّرًا على نحو بالغ الوضوح. إنّ تغلغلها المجهريّ يفتّت التفاصيل في تفاصيل أخرى، وهذا حقيقيّ، بالنسبة إلى التمييز السيكولوجيّ، مثلما هو، كذلك، بالنسبة إلى التمييز الماديّ، أيضًا. وليست رؤيته، على أية حال، هي تلك التي لعالِم -مثلما قد يشي بذلك تصويري لها- بل إنها لواحد يعشق جيدًا التنوّع المطلق للحياة في كل تجليّاتها، فلا تفصيل ينبغي أن يظلَّ غير مرصود، أو غير محتفىً به البتّة، بل يتوجّب مقاربته بتبجيل ورهبة وحُبّ، ثم ملاطفته وضمّه، والانشداه منه والذهول، كذلك، أيضًا. إنّ الأشياءَ في ذواتها، في كينونتها ليس إلّا، معجزة وجديرة بحبّ الإنسان. لذلك، نرى كيف تنبض أبياته بدفء جُوَّانيٍّ وبرَّانيٍّ، وكيف تتّقد بالحسيّة. كالمرايا، تعكس الأبياتُ مصدر الضّوء والحبّ المتأصّل في عينيّ الشاعر وفي رؤيته. آنئذ، ندرك، كدهشة عظيمة، كهزّة أو تكادُ، بأنّ قصائد الحبّ، أو القصائد الإيروتيكيّة، في حدّ ذاتها، غير موجودة، على نحو عمليّ، في آثار ريتسوس الضخمة.
في الواقع، وحسب ما أعرف، فإنّه لم يكتب سوى ثلاث قصائد من هذا النّوع. إنّها تشمل العمل الحاليّ، حيث تبلغ قصيدتاه السّابقتان ذروتيهما. يذكّرنا عنوان القصيدة الأولى، «نشيد إلى إيروتاس Erotas» -والتي كتبت في 1934، عندما كان الشاعر في الخامسة والعشرين، ونشرت في كتابه الثّاني، أهرامات (1935)- بتمييز جرى عبر اليونانيّة القديمة إلى الحديثة، والذي يبدو أنّ اللّسان الأنغلو-أميركيّ لم يكن في حاجة إليه البتّة. فَـ erotas وَ aghapi تستخدمان، في اليونانيّة، بما يربطه الأنغلو-أميركيّون من عواطف وغراميّات بكلمة «حُبّ love»؛ وعلى الرّغم من أنّ erotas، في اليونانيّة، تحمل تلميحات/تضمينات حسيّة أكثر من aghapi، فإنّها غير مقصورة تمامًا، كما في الإنجليزيّة، على الجانب الجنسيّ للحُبّ. إنّ «قصيدة غنائيّة إلى إيروتاس» تمرينٌ أدبيّ في رباعيّات إيامبيّة مقفّاة تستحضر المفهوم المجرّد للحبّ الحسيّ (غير الجنسيّ) كما تمّ إنشاده على نحو أبديّ في السّرائر الرومانتيكيّة للشعراء. فعدم الإشارة إلى حادثة معيّنة، وعدم مناجاة جسد معشوق أو حبيبة، هما الاستحضار الأمثل لعاطفة بلا تجسيد.
ولا يعني ذلك القول إنّ القصيدة لا تستلهم أيّة تجربة بعينها. هنا، كان ريتسوس يؤدّي الدّور التقليديّ للشّاعر في التفكير المثاليّ وفي التجريد، وفي إضفاء بُعْدٍ كونيّ أيضًا. فبعد بضع سنين، على أيّة حال، في 1937-38، كتب قصيدة طويلة في سبعة وثلاثين جزءًا، بعنوان «سيمفونيّة الرّبيع»، حيث نستطيع، عبر موتيفاتها الموسيقية وتفاصيلها الغنائيّة، رؤيةَ حادثة محدّدة عن عشّاق أحبّوا بعضهم حسيًّا، ثمّ افترقوا محزونين. يتكلّم الشاعر عن عزلته اللّانهائية فوق قمّة ثلجية (كان ريتسوس، في ذلك الوقت، قد أدخل، لقضاء سنتين اثنتين، للعلاج من مرض السلّ، في مصحّة على جبل بارنيثا قرب أثينا)، وعن قدره المأساويّ الكئيب (فقد ماتت أمّه وأخوه بداء السلّ)، وعن العالم الفتّاك في الخارج (كانت ديكتاتوريّة ميتاكساس في أوج استبدادها). تأتي المحبوبة إليه في الضّوء والأمل، وحبّهما «يملأُ الصّدع اللّانهائيّ/ بأجنحةٍ وأزهارٍ». إنها تجلب له المسرّة والحبّ في غرفة يجعلانها كونهما، فيحتفي بجسدها العاري الذي من خلاله ينهمك في وحدة الكون. يعقب ربيعَ الحبّ صيفُ الوفاء والتحقُّق، ثمّ، وعلى نحو حتميّ، خريفُ القمر الأصفر لشهر نوفمبر، حين تسقط أوراق الأشجار والموت «يختبئ تحت سريرنا/ ويصنع مزامير من عظام/ سنونوات ميّتة». بأمل متجدّد، يدرك الشّاعر بأنّ حبّه لها ليس سوى حبّ رمزيّ يدلّ على حبّه للخلق والإبداع، وبأنّ «خلف حديقتنا حدائقُ أخرى»، وأنّه لا يفترق عنها إلّا لينجز قدره الحتميّ كشاعر، متحرّر من كلّ القيود.»
من “مقدّمة” كيمون فريار